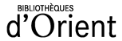لم تنشط الدراسة العلمية في تدمر حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فابتداءً من عام ١٨٦٠ حلَ العلماء محلَّ المغامرين وشرعوا في المجيء إلى تدمر بهدف العمل فيها.
على الرغم من أن إعادة اكتشاف تدمر في نهاية القرن السابع عشر يعود إلى التجار الإنجليز الذين قدموا من حلب عام ١٦٧٨، وأن أول منشور "ناجح" كان لـ"عالمي الآثار المتجولين" الإنجليزيين ر. وود وج. دوكينز (مع الرسام الإيطالي ج. ب. بورا) عام ١٧٥١، إلا أن فرنسيين اثنين على الأقل، هما السيدان جيرو وسوتيه، زارا المدينة منذ عام ١٧٠٥، وتبعهما كلود جرانجر عام ١٧٣٦. لا نعرف أي معلومات عنهما، لكن جيرو رسم منظرًا بانوراميًا رائعًا للآثار، وهو مفقود الآن، ولكن نسخة منه للنقّاش ب. ج. مارييت محفوظة في مكتبة المعهد. هذا المنظر جديرٌ بالملاحظة، كما قدمه الهولندي ج. هوفستيد فان إيسن منذ عام ١٦٩١. وفي عام ١٧٨٥، قضى الرسّام الفرنسي الموهوب ل. فر. كاساس (١٧٥٦ــ١٨٢٧) عدة أسابيع في تدمر، أنجز فيها مئات الرسوم والرسوم المائية حيث قاده خياله في بعض الأحيان إلى تجميل الواقع إلى حد ما. وكان للفرنسيين أيضا حصة ملحوظة في البحث العلمي، الذي اتّخذ بعد ذلك خطواته الأولى. في عام ١٧٥٤، وبالتزامن مع القس الإنجليزي ج. سوينتون، تمكن رئيس الدير ج. ج. بارتيليمي (١٧١٦-١٧٩٥) من فك رموز اللغة التدمرية، مُثبتًا أنها لهجة آرامية. وأصبحت النصوص العديدة باليونانية والتدمرية من الموقع تُستخدم الآن لتدوين تاريخها. وفي عام ١٧٥٨، قدّم ج. جوف (١٧٠١-١٧٥٨)، وهو يسوعي من ليون، أول تاريخ لزنوبيا، مُتحرّرًا من الأساطير المُكررة باستمرار، مُستندًا إلى السرد الرومانسي لتاريخ أوغسطس، مُستخدمًا نقوشًا وعملات معدنية مُكتشفة حديثًا.
على الرغم من ذلك، لم تنطلق الدراسة العلمية لتدمر فعليًا إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في الواقع، منذ ستينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا، حلَّ العلماء محلَّ المغامرين و بدأوا يتوافدون إلى تدمر للعمل فيها. لقد مرّت بضع سنوات منذ أن بدأ الاهتمام بالصور الجنائزية المستخرجة من القبور، بعد أن كانت المومياء وحدها محور الانتباه حتى ذلك الحين، والتي أصبحت فيما بعد تملأ المجموعات الخاصة والمتاحف. وفي عام 1891، تم اكتشاف النقش الكبير الثنائي اللغة المعروف باسم "تعريفة تدمر" ، الذي كان يحدّد قواعد الجباية البلدية. وقد أُهدي هذا اللوح إلى الأمير الروسي أ. لازاريف من قبل السلطان عبد الحميد الثاني، ثم قُطع إلى أربع قطع وأُرسل إلى سانت بطرسبرغ عام 1901. واحتل العلماء الألمان (أو. بوششتاين، م. سوبيرنهايم، ثيودور فيغاند) وعدد من الفرنسيين مكانة بارزة في اكتشاف ونشر نقوش المدينة المكتوبة بالآرامية أو باليونانية؛ من بينهم دبليو. هـ. وادينغتون عام 1861 في مجال النقوش اليونانية، ور. سافينياك وزملاؤه من مدرسة الكتاب المقدس في القدس عام 1914، بينما برز جان-باتيست شابو (1860-1946)، رغم أنه لم يزر تدمر قط، كأبرز المتخصصين في نقوش تدمر الأثرية.
ومن الغريب أن تضاعف عدد نسخ النقوش والسجلات الأثرية الموجزة لم يُحقق تقدما في معرفة تاريخ تدمر. ومن المؤكد أن لا أحد كان يشكّ في أهمية الموقع،غير أنّه، رغم عدم إنكار السمات المأخوذة من الفنّ الإغريقي-الروماني في حوض البحر المتوسط، فقد فُضّل التأكيد على أهمية التقاليد المحلية، واعتُبرت الثقافة الإغريقية-الرومانية «سطحية». وقد عزّز هذا التحليل كون أن أحدا لم يتساءل حقا عن وضع المدينة، والتي كانت تُعتبر مملكةٍ تابعةٍ تعمل كمنطقةٍ عازلة بين روما وبلاد ما بين النهرين من البارثيين ثم الفرس.لم يشكّ أحد في أن زنوبيا كانت «ملكة تدمر»، على الرغم من أن أي نصٍّ قديم لا يمنحها هذا اللقب، وأن النقود تصفها – من دون أي مجال للشك بأنها إمبراطورة روما. وهذا ما أكده أيضًا التاريخ الأوغستي، إذ يضع سيرتها، مهما كانت خيالية، ضمن سير الأباطرة الرومان.
ومع وجود الانتداب الفرنسي على سوريا وإنشاء خدمة للآثار عام ١٩٢٠، تغير نطاق البحث الأثري وكانت تدمر إحدى المستفيدين الرئيسيين. وأتبع الدّراسات الاستقصائية المُتسرّعة والتي في كثير من الأحيان لم تشهد أية مُتابعة تُذكر تنفيذٌ لبرامج عمل حقيقية على المباني الرئيسية للمدينة. وهكذا تمّ تجريف الرواق الكبير وإعادة تركيب القوس الكبير الواقع بين القطاعين أ و ب من الرواق الكبير. وتمت دراسة أسوار المدينة (المُتأخّرة) من قبل أ. غابرييل، أما دائرة الآثار فقد شرعت عام ١٩٢٩ ، تحت رعاية هنري سيريج متبوع بروبرت آمي، في تنظيف معبد بل والمساكن المكتظة حوله. نُشرت بين عامي 1975 و1982 دراسة ضخمة لهذه الأعمال، التي كان إرنست ويل قد شارك فيها بعد الحرب. في الوقت نفسه، تم استكشاف المقابر، حيث تم استخراج عدد كبير من التماثيل النصفيّة والنقوش. وكان عدد هذه النقوش كبيرًا إلى درجة أن ج. كانتينو أطلق جردًا للنقوش في تدمر، ونشر بمفرده تسع مجلدات بين عامي 1930 و1933. واستمرّ الأب ج. ستاركي، الذي عُين ككاهن في تدمر (حيث كانت تتمركز حامية فرنسية)، في متابعة أعمال كانتينو في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين.
لعبت السلطة الانتدابية دورا أساسيا، ولكن أُسندت المشاريع لبعثات أجنبية، في تدمر كما في أمكنة أخرى في سوريا. أجرى الدنماركي ه. إنغولت ثلاث بعثات تنقيب في تدمر في العشرينيات الأولى من القرن العشرين اكتشف من خلالها أكثر من خمسين مقبرة مع السيد دوناند عام ١٩٢٤، ثم مع أ. غابرييل عام ١٩٢٥، ثم مع مهندس معماري دانمركي عام ١٩٢٩، ثم نقب في منتصف الثلاثينيات في قبر مالكو إبن مالكو في القبر الجنوبي الغربي. ساهم إسهامًا كبيرًا في إثراء متحف ني كارلسبرغ غليبتوتيك في كوبنهاغن، ونُسب إليه على وجه الخصوص تمثال "جمال تدمر"، وهو تمثال نصفي لامرأة عُثر عليه في مقبرة القصر الأبيض بوادي القبور. كما ارتبط اسم الباحث نفسه بنشر "تيسيرا" وهي عبارة عن ألواح صغيرة أو قطع أو رموز، تُستخدم كعلامات تمييز والتي لم تُكتمل إلا في منتصف خمسينيات القرن العشرين.
وقد رافقت الأعمال الأثرية إعادة تقييم الأهمية التاريخية لتدمر، على الرغم من ان التقدم في هذا المجال كان بطيئا، ربما لأنه باستثناء قلة من الباحثين الذين، مثل هـ. سيريغ، كانوا يتمتعون بمعرفة شاملة بالعالم اليوناني الروماني، كانت المناطق الداخلية من سوريا حكرًا على اللغويين وعلماء الآثار المتخصصين. وبينما لم يكن لدى سيريغ أدنى شك في انضمام تدمر إلى الإمبراطورية الرومانية، وضع د. شلمبرجير أسس تحليل مؤسسات تدمر في إطار المؤسسات المدنية ذات الطابع اليوناني. والأكثر إثارة للاهتمام أن شلمبرجير نفسه وضع لاحقًا الفن التدمري في سياق أوسع في مقال أساسي بعنوان "أحفاد الفن اليوناني غير المتوسطيين"، نُشر عام ١٩٦٠. مع ذلك، ظلت تدمر في نظر الكثيرين مملكة هامشية ذات وضع غير مؤكد، أكثر إثارة للاهتمام لما تقدمه من ثراء لا لتاريخها الخاص.
مع نهاية الانتداب الفرنسي واستقلال سوريا، تضاعفت الأعمال، سواءً من خلال الترميمات أو الحفريات على نطاق أوسع من التنقيبات في (معبد بل ومعبد نابو). عملت بعثات من جميع أنحاء العالم في تدمر، بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا بشكل متزايد: البعثة السويسرية في معبد بعل شمين؛ البعثة البولندية في معسكر دقلديانوس، ومعبد اللات، وضريح مارونا، وفي المنازل الواقعة شمال الرواق الكبير وفي الكنائس؛ البعثة الفرنسية في الاغورا الساحة، وضريح الإخوة الثلاثة؛ البعثة اليابانية في المقابر الجنوبية الشرقية والشمالية؛ البعثة الأمريكية في نبع أفقا؛ البعثة الألمانية في الضريح 36 وفي الحي "الهلنستي" المزعوم، وكذلك في المحاجر شمال المدينة؛ البعثة الإيطالية في الحي الجنوبي الغربي من المدينة؛ البعثة النرويجية في الجبال الشمالية الشرقية.
استمرت الاشكاليات في الإثراء والتعديل وفقا الاكتشافات وخصوصاً اهتمامات المجتمعات المعاصرة، التي طالما شوّهتها الأساطير المرتبطة بزنوبيا والصور النمطية للشرق والنظرة الرومانسية للصحراء. لم يعد الطابع المتعدد الثقافات للمدينة القديمة يبدو غريباً بالنسبة لمجتمعاتنا المعاصرة، كما قد مضى الزمن الذي كنا نقيس فيه درجة "حضارة" المجتمعات الأولية بمدى مُطابقتها للإغريق. على النقيض من ذلك، تُعتبر تدمر اليوم مثالاً يُحتذى به لمجتمع استطاع أن يتبنى ما يناسبه من التأثيرات اليونانية الرومانية دون أن يفقد هويته العميقة. لا شك أن العديد من الأساطير حول تدمر لا تزال رائجة، والعديد من الصور النمطية التي يبذل المؤرخون جهدا لمكافحتها. يستمد القوميون بشكل مبالغ فيه أفكارهم من التقليد الغربي المستشرف للشرق ليجعلوا من زنوبيا رمزًا مبكرًا للنضال ضد الاستعمار، بينما في الحقيقة، وبعيدًا عن تصويرها كملكة لامبراطورية "مملكة تدمر" الافتراضية، كانت زنوبيا تعلن نفسها بوضوح إمبراطورة روما. وفي نفس الاتجاه عمل أولئك الذين أبَوا ألا يروا في المكونات اليونانية والرومانية داخل ثقافة تدمر، والتي هي بالتأكيد مركبة حتى لا نقول عالمية، سوى طلاء سطحي، نوع من "الحداثة"، كما لو أن قرار تزيين قبر أو منزل بصباغة أو فسيفساء مقرونة بموضوعات أسطورية يونانية استُخدِمت في الآن نفسه من قبل فلاسفة أفلاطونيين مُحدثين كان فقط مسألة موضة، سطحية المظهر، مهتمة فقط بالتمييز الاجتماعي. إن وجب العثور على طلاء سطحي في مكان ما، فإنه أولا وقبل كل شيء في هذا النوع من التحاليل المعمّمة التي تختزل جميع الأفراد في دوافع مماثلة، دون أن تعير أي تقدير للمشاعر الحميمية لكل واحد منهم. لا يمكن اختزال مجتمع تدمر الغني والنابض بالحياة في هذه الرسوم الكاريكاتورية، حيث لا يزال تنوعه وأصالته يحملان لنا الكثير لنتعلمه.
شرح الصورة : منظور عام لمدينة تدمر الشّهيرة.