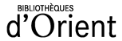تحكي القصة أنه في يوم ربيعي جميل من عام 1947، اكتشف راعي بدوي شاب، أثناء بحثه عن عنزة مفقودة، في كهف بعض الجرار الفخارية التي تحتوي على مخطوطات مغطاة بكتابات قديمة. هل كان البدو يطاردون حيوانًا حقًا؟ هل كانوا يعرفون بوجود هذه المخطوطات المخفية؟ هل كانت حقًا في جرار؟ ماذا كانت تحتوي؟ لمن تنتمي؟ من كتبها ونسخها؟ ... هذه كلها أسئلة تترأس الملحمة غير العادية لاكتشاف مخطوطات البحر الميت، وهي ملحمة ذات رهانات متعددة أثارت على مدار ما يقرب من ستين عامًا نقاشات وأسئلة تتجدد باستمرار مع تقدم البحث. لأن هذا الاكتشاف، الذي يُعتبر أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين، لا يزال يثير التساؤلات حول أسس اليهودية والمسيحية، اللتين تجدان نفسيهما مرتبطتين أكثر من أي وقت مضى بهذه المكتبة الغامضة المدفونة في الصحراء.
سرعان ما سعى البدو إلى الاستفادة من اكتشافهم. فعرضوه على تاجرين من أعضاء الكنيسة السريانية، اللذين بدورهما عرضاه على رئيس دير القديس مرقس في القدس، المطران مار أثناسيوس صموئيل. وفي الأثناء، وصلت مخطوطات أخرى اكتشفها البدو، عن طريق وسيط آخر، إلى البروفيسور إليعازر سوكنيك من الجامعة العبرية في القدس، الذي اقتنع بسرعة بأهمية الاكتشاف، وسعى إلى شراء جميع اللفائف التي تم العثور عليها، وخاصة تلك التي كانت في حوزة المطران مار صموئيل. غير أن هذا الأخير، معتقدًا أنه قد يحقق فائدة أكبر في الخارج، قرر الاحتفاظ بلفائفه ومحاولة بيعها في الولايات المتحدة. ولكن بعد أن فشل في بيعها، نشر إعلانًا في صحيفة عام 1954. وقد كان ابن سوكنيك نفسه (الذي توفي عام 1953)، ييغال يادين، هو من اشتراها مستخدمًا اسمًا مستعارًا حتى لا يثير الشبهات. ولم يُبلّغ مدير المدرسة الكتاب المقدس والآثار في القدس، الأب رولان دو فو، ومدير دائرة الآثار الأردنية، جيرالد لانكستر هاردينغ، بوقوع هذا الاكتشاف إلا بعد عامين من العثور على اللفائف الأولى، أي في عام 1949، وذلك من خلال منشور أمريكي. فأطلقا على الفور حملة تنقيب، وبدأت بذلك «سباق المخطوطات» الحقيقي. حيث دخل علماء الآثار التابعون للمدارس الأثرية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية في القدس في منافسة مباشرة مع البدو في منحدرات الموقع. كما امتد السباق إلى سوق الآثار، في ظل التوترات التي صاحبت إنشاء دولة إسرائيل.
بين عامي 1947 و1955، كُشف عن أسرار إحدى عشرة مغارة من بين نحو مئة مغارة تمت زيارتها، حيث أُخرج منها نحو 900 مخطوطة، مكوّنة من مئات الآلاف من المخطوطات. ويمثل هذا العدد بلا شك جزءًا ضئيلًا مما كان موجودًا في الأصل. فمع مرور القرون، دُمّر عدد كبير من هذه المخطوطات بسبب العوامل المناخية القاسية، في حين عُثر على بعضها الآخر أو سُرق أو تفرّق في أماكن شتى. وفي مطلع القرن الثاني الميلادي، ذكر العالم اللاهوتي الكبير أوريجانوس أنه عثر على نسخة مجهولة من المزامير داخل جرة. أما في القرن الثاني عشر، فقد روى تيموثاوس، بطريرك بغداد، أن صيادًا عربيًا كان يبحث عن كلبه فاكتشف مغارة مليئة بالكتب. وهكذا، يبدو أن أماكن إخفاء هذه المخطوطات كانت تُكشف بين الحين والآخر عبر العصور. كما كشفت مغارات أخرى مجاورة لتلك عن جرار مكسورة وأقمشة، مما يوحي بأنها كانت تحتوي هي الأخرى على لفائف.
تنتمي جميع هذه الكتابات إلى الأدب الديني اليهودي الذي سبق سقوط هيكل القدس عام 70 ميلادية. ولم يُعثر على أي نوع آخر من الوثائق — لا إدارية، ولا تجارية، ولا مراسلات، ولا أرشيفات خاصة — باستثناء لفافة نحاسية غامضة تُعدّ بمثابة خريطة كنز، لا تزال دلالتها الحقيقية مجهولة حتى اليوم. في البداية، قسّم الباحثون الأوائل هذه المخطوطات إلى فئتين: «كتابات دينية» و«كتابات غير دينية». لكن مع تقدم عملية فكّ النصوص، تناقصت نسبة المخطوطات التي لها علاقة بالكتاب المقدس — أي تلك التي تم تحديدها على أنها جزء من قانون الكتاب المقدس العبري والمسيحي (العهد القديم) — حتى أصبحت لا تتجاوز نحو 25٪ من المجموع، مقابل ازدياد عدد النصوص الدينية الأخرى غير الموجودة في الكتاب المقدس، والتي أُطلق عليها اسم «الأبوكريفا»، أي «الخفية» أو «المستبعدة» من القانون الكتابي.
ومع ذلك، فإن معظم هذه النصوص يرتبط بكتب دينية معروفة، ويقدّم قراءات أو نسخًا جديدة منها. ورغم اختفائها من النسخة الرسمية، فقد بقيت آثارها في التقاليد الشعبية، ووصل إلينا عدد منها عبر نسخ من العصور الوسطى، يهودية كانت أو مسيحية. أما بعض هذه النصوص، فقد كان مجهولًا تمامًا قبل هذا الاكتشاف.