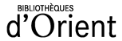في قلب العالم العربي، في المشرق، "الشرق"، - وهو حيّز جغرافي يشمل مصر وسوريا وفلسطين وإسرائيل ولبنان والأردن والعراق- ولدت الديانة المسيحية وعرفت أول انتشار لها. حافظت كنائس الشرق الأدنى على تنوّعها الليتورجي الأصلي وكذلك على تنوّعها اللاهوتي.
كانت الديانة المسيحية الأولى غنية بالاعتبارات المتنوعة الموروثة عن عدم التجانس في الديانة اليهودية التي تأصّل فيها المعتقد الجديد. في القرن التاسع، اضفي على الكنائس الطابع المؤسسي في الإمبراطورية الرومانية مما ساهم في بروز أرثودكسية تحددت في مجمع نيقية (عام 325) وترافق ذلك مع تصلّب في الخطاب الثيولوجي. وتزامناً مع تحوّل المسيحية إلى ديانة دولة (الوضع الذي توصلت إليه منذ العام 380 مع وصول تيودوسيوس إمبراطور نيقية إلى الحكم)، شكّل التنوّع الأولي مصدراً للانشقاقات. بعد مجمع أفسس (عام 431) ومجمع خلقيدون (عام 451)، نشأت فروع متعارضة فيما بينها انبثقت عن مدارس ثيولوجيّة مختلفة الكريستيولوجيات. والتقلبات التاريخية اللاحقة، لاسيما التدخلات من جانب الغرب، زادت في حدة هذه الانقسامات، ونستطيع أن نميّز فيما بينها:
- الكنائس "الخلقيدونية" التي عُرفت قديماً بــ"الملكية" (من السريانية "مالكو" التي تعني "الملك" لأن هذه الكنائس أدت الولاء للإمبراطور البيزنطي)، وكانت تتبع العقيدة الخلقيدونية فاعتبرت أنّ للمسيح طبيعتين وأنّ هناك اتحاد في شخص المسيح ابن الله، المخلّص المولود من مريم العذراء المكرّمة في هذا الصدد بمثابة "أم الله". وشكّل الملكيّون أغلبية في سوريا وفلسطين (بطريركية أنطاكيا وبطريركية القدس)، وأصبحوا أقلية فيما بعد (بطريركية الإسكندرية). في القرن الحادي عشر، انجرفت هذه الكنائس مع القسطنطينية في الانشقاق الذي أدى في عام 1054 إلى الانفصال عن روما. اعتمدت فيما بعد بشكل تدريجي الليتورجيا البيزنطية وأصبحت حالياً تنتمي إلى ما يعرف بالكنائس "الأرذودكسية".
- الكنائس المعروفة سابقاً بالــ"مونوفيزية" (الأقباط في مصر، والأثيوبيون، والأرمن، والسريان) وهي كنائس وريثة الأنثروبولوجيا التي تعتبر أن وحدة شخص يسوع كاملة لدرجة أننا لا نستطيع، بعد أن تجسّد، اعتبار طبيعته البشرية منفصلة عن طبيعته الإلهية إنما هو ذات طبيعة واحدة إلهية-بشرية (باليونانية: monè physis).
- الكنيسة المعروفة بالــ"النسطورية" (نسبة لــ"نسطوريوس" بطريرك القسطنطينية الذي حوكم في أفسس) وأصبحت تعرف فيما بعد، منذ القرن التاسع عشر، بالكنيسة "الأشورية"، أي كنيسة مسيحيّي العراق وإيران. وتتعلّق بمدرسة أنطاكية التي تؤكد على مبدأ الجوهر البشري والجوهر الإلهي ليسوع، دون أن يكون اتحاد بينهما وفي نفس الوقت دون الفصل بينهما. واعتبرت أنّ وصف مريم بــ"أم الله" يفتح الباب أمام إخفاء الجوهر البشري ليسوع.
- الكنائس الكاثوليكية الشرقية ، ظهرت ابتداءً من القرن السادس عشر عند الالتحاق بروما من جانب مجموعة من المؤمنين غير الخلقيدونيين وغير الملكيّين، مما أدى إلى نشوء كنائس "باباوية" وهي: كنيسة الأقباط الكاثوليك، وكنيسة السريان الكاثوليك، وكنيسة الكلدان الكاثوليك (المنبثقة عن الكنيسة النسطورية)، وكنيسة الأرمن الكاثوليك، وكنيسة الملكيين الكاثوليك (التي احتفظت بالتسمية " الملكيين" في حين تخلّت كنيستها الأم "الأورثودكسية" عن هذه التسمية). وقعت هذه الكنائس تحت التأثير اللاهوتي أو الثيولوجي اللاتيني بشكل واضح نسبياً. هناك حالة خاصة هي الكنيسة المارونية (في لبنان وسوريا وقبرص) التي اتحدت مع روما منذ الأصل دون أن تكون منفصلة عن تراث الكنيسة "الأورثوذكسية".
- كما وأسست روما في الشرق الأوسط طوائف "لاتينية" منذ فترة الحملات الصليبية. واستعادت هذه الحركة نشاطها في القرن التاسع عشر مع إنشاء بطريركية اللاتين في القدس.
- في الوقت عينه، تشكلت بصورة تنافسية طوائف متنوعة بروتستانتينية أو إنجليكانية في سائر بلدان المنطقة.
خلال فترة الفتح العربي، في القرن السابع ميلادي، كان المسيحيون يشكلون تقريباً النسبة الإجمالية لشعوب الشرق الأوسط. وانقسامهم لعب دوراً في السرعة التي فرض بها الفاتحون سيطرتهم ، دون أن تؤدي بهم هذه السيطرة إلى اعتناق الإسلام أو إلى تعلّم اللغة العربية بشكل سريع في هذه الأقطار. وخلال فترة طويلة، بقيت الشعوب المحلية بأغلبيتها مسيحية وحافظت على لغاتها القديمة (القبطية في مصر، واللهجات الآرامية المتنوعة في سوريا وبلاد ما بين النهرين). واعتمدت بجانب ذلك اللغة العربية ابتداءً من القرن العاشر، مما ساهم في ولادة أدب عربي مسيحي خاص. وعملية التعريب هذه أدت إلى اضمحلال اللغات القديمة أو اندثارها أو تقليص اثرها. وبالتالي تطوّرت بشكل طبيعي ثيولوجيا مسيحية "عربية" بلهجات خاصة نتيجة المسائل المطروحة في إطار الحوار مع الإسلام. ولعب المسيحيون دوراً رائداً في نضال العرب: النهضة في مجال الهوية الثقافية العربية ضمن الإمبراطورية العثمانية، والنضال ضد الاستعمار الغربي، والعروبة السياسية، ومعارضة الدولة الصهيونية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها. وبفعل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية، في الدرجة الأولى، ثم العوامل الدينية المعقدة، اعتنق السكان المسيحيون الإسلام بأغلبيتهم. وكانت عملية الأسلمة بطيئة تدريجياً ولم تصل إلى درجة الاختفاء الكامل للمسيحيين. وسمح المجتمع المسلم التقليدي لغير المسلمين (أهل الذمة) بممارسة عقائدهم. وبالطبع، مع انتشار الإسلام الذي أصبح مسيطراً، بات المسيحيون يشكلون أقلية فتدهور وضعهم ووقعوا أحياناً ضحية التمييز والعنف إنما بشكل متفرّق، ونادراً ما وصل ذلك إلى درجة القضاء عليهم. وكانت التبادلات الثقافية بين المسلمين والمسيحيين غنية وعرفت عصراً ذهبياً من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، في مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين.
بدأ عدد المسيحيين في الشرق الأوسط يتراجع بشكل ملحوظ، لا سيما ابتداءً من القرن الرابع عشر. وكان للإكراه على الأسلمة دوراً في هذه الظاهرة، دون أن يشكل هذا البعد سببها الوحيد. كما أنّ التراجع في عدد المسيحيين لم يكن متواصلاً بشكل دائم، ففي ظل الإمبراطورية العثمانية، أي ابتداءً من القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين، عرفت الطوائف المسيحية في المشرق من جديد نمواً ديموغرافياً.
شهد القرن العشرون تراجعاً في نسبة المسيحيين في المشرق. فبعد أن كانوا يمثلون نسبة تتراوح ما بين 10% و15% من العدد الإجمالي لسكان الشرق الأدنى العربي حوالى العام 1900، تراجع عددهم بشكل ملحوظ ليصل إلى نسبة تتراوح بين 6% و8%. ولكن عددهم المطلق حالياً (ما يناهز الــ10 مليون) يفوق عددهم قبل مئة سنة (أقل من مليونين)، كما أنّ طوائفهم أشد حيوية، وهي أكثر انفتاحاً على الحداثة. غير أنّها تعاني من الضيق العام الذي يسود المجتمعات العربية وأسباب هذا الوضع عديدة: عدم الثبات المزمن في المنطقة من جرّاء الصراع العربي-الإسرائيلي، نتيجةً لذلك، استحالةُ تطوير ديمقراطيات مواطنة حقيقية، وحصار المجتمعات من قِبل أنظمة ديكتاتورية واستغلالية، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى صعود الإسلام السياسي. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تفاقم هذا الشعور بانعدام الأمن لدى المسيحيين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مشروع اجتماعي-سياسي مُستبعدين منه. ونتيجةً لذلك، اختار الكثير منهم طريق المنفى. إن الأزمات المتزايدة التي شهدها العالم العربي منذ بداية الألفية الثالثة، والانفلات الاجتماعي الذي أعقب "الربيع العربي"، والذي أدى تحديدًا إلى تفكك العراق وسوريا، وإضعاف مصر بشكل خطير، تُلقي بظلالها على آفاق مستقبل هذه المجتمعات.
الصورة: مجموعة رسوم تبيّن حياة المسيح، مع شروحات بالسريانية وبالأرمنية. القرن السادس عشر.