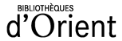في ظلّ الاتصالات والاحتكاكات التي شهدها القرن التاسع عشر بين الدول الأوروبية وبلاد المشرق، ازدادت المنشورات حول الإسلام، من إنتاج من كان يُطلق عليهم آنذاك اسم "المستشرقين".
يمكن القول إن المشهد الديني في الإسلام المركزي قد ظل محدود التطور في فجر العصر الحديث. وهذا لم يكن عديمَ الصلة بالاستقرار الداخلي للإمبراطوريات التي استمر وجودها منذ القرن 16 الميلادي، سواء تعلق الأمر بإمبراطورية الأتراك العثمانيين، أو بإمبراطورية الإيرانيين الصفويين، أو بالإمبراطورية الهندية التي أقامها المغول. سيطرت الإمبراطورية العثمانية، وهي أقدم هذه الإمبراطوريات الثلاث، على كامل المشرق ثم على مصر منذ 1516-1517. وعلى الرغم من أنها غالبا ما كانت منشغلة في حروب خارجية، فقد استطاعت أن تحافظ في داخلها على تنوع ديني ملحوظ مع أن الإسلام قد ظل بطبيعة الحال هو الدين الرسمي. فجزء كبير من اليهود المطرودين من إسبانيا بموجب مرسوم 1492 كانوا قد وجدوا ملجأً في الأراضي العثمانية. أما فيما يتعلق بالاتجاهات الدينية المختلفة التي حفل بها الإسلام نفسه، بدءاً بالمُنتَج الفقهي وانتهاءً بعلم الكلام والتصوف، وهي الاتجاهات التي كانت نشأتُها في القرون الخمسة أو الستة الأولى للإسلام محكومةً في غالب الأحيان بالصراع والجدال، فإنها كانت قد انتهت إلى الانتظام انتظاماً مؤسسياً في إطار الإدارة الإمبراطورية.
فيما يخصّ التبادلات، فإنّ موانئ المشرق – أو ما كان يُعرف بـمحطات التوقف البحرية التي كانت تمنح امتيازات تجارية وقانونية مهمة – قد نظّمت العلاقات مع مملكة فرنسا منذ عام 1536. أما الاتفاقيات المعروفة باسم "الامتيازات" ، والمرتبطة بهذه الموانئ وبعض المدن الداخلية مثل حلب ودمشق والقاهرة، فلم يُلغَ العمل بها إلا عام 1914، حينما، وفي خضمّ أهوال الحرب العالمية الأولى، انضمّ آخر السلاطين العثمانيين – الذي كان يواجه منذ عقود خسائر كبرى في الأراضي – إلى ألمانيا. لقد بدأ التدخّل الفرنسي في شؤون المشرق منذ مطلع القرن التاسع عشر، مع حملة بونابرت على مصر (1798–1805)، ثمّ تولّى البريطانيون الدور ذاته خلال النصف الثاني من ذلك القرن.وقبل هذا الصدام الحادّ مع الحداثة، كانت موانئ المشرق تستقبل أنواعًا مختلفة من المسافرين. ومن بين الشخصيات المميزة التي يمكن ذكرها أنطوان جوزيف دو كورواي (1775–1853)، الذي شغل منصب مدير مدرسة الشبان المترجمين في القسطنطينية، حيث كان يُدرَّب المترجمون المستقبليون في خدمة ملوك فرنسا. وكان هؤلاء المترجمون، الذين عُرفوا باسم الدراغومان، يشكّلون غالبًا وسطاء فعّالين في نقل المخطوطات التي كان المستشرقون المقيمون في أوروبا بحاجة إليها، مثل سلفستر دو ساسي (1758–1838)، المتخصص في اللغتين العربية والفارسية، والذي كان على تواصل مراسلاتي مع دو كورواي. وعبر قنوات مشابهة، وصلت إلى فرنسا أوراق قرآنية من القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، اقتناها جان-لويس أسلان دو شرفيل (1772–1822)، وهو وكيل قنصلي فرنسي كان مقيمًا في مصر.كما قام الطبيب أنطوان كلوت المعروف بـ كلوت بك (1796–1868)، الذي أسس مستشفى في القاهرة، بنقل عدد كبير من المخطوطات أيضًا.
بعيدًا عن أولئك الذين انشغلوا بجمع الوثائق والمخطوطات، برز أيضًا عدد من المراقبين والرحالة الذين تركوا لنا دراسات وأبحاثًا تشهد على زمنهم. ويمكن تمييز تيارين فكريين رئيسيين في هذا المجال. الأول، امتدادٌ للتساؤلات التي كان قد أثارها كتّاب القرن الثامن عشر خلال احتكاكهم بالمشرق. ففي هذا السياق، نشر جول بارتلمي سانت هيلير عام 1865 مؤلفه محمد والقرآن، متضمّنًا مقدمة حول الواجبات المتبادلة بين الفلسفة والدين. وعلى المنوال ذاته، قدّم باسيفيك-هنري ديلابورت عام 1874 كتابه حياة محمد. أمّا الدراغومان البولندي ذو الأصل الهنغاري كازيميرسكي، فقد أنجز عام 1840 ما يُعدّ بحق أول ترجمة حديثة للقرآن إلى اللغة الفرنسية. أما التيار الثاني، فقد انصرف إلى دراسة التيارات الإسلامية غير السائدة، أي تلك التي شكّلت أقليات داخل العالم الإسلامي. ومن بين ممثليه جان-باتيست روسو، الذي نشر عام 1818 دراسة بعنوان مذكرة حول الطوائف الثلاث الأشهر في الإسلام: الوهابية، والنصيرية، والإسماعيلية. كانت الطائفتان الأخيرتان النصيريون (العلويون حاليًا) والإسماعيليون ذوات جذورٍ تعود إلى العصور الوسطى، وتنتشر خصوصًا في سوريا، في حين أن الوهابية كانت ظاهرة حديثة العهد نسبيًا، نشأت في شرق الجزيرة العربية منتصف القرن الثامن عشر. وقد لفت هذا التيار الأنظار منذ بدايته بفضل حدة خطابه وتشدد مبادئه، مما دفع خديوي مصر، وبطلبٍ من الدولة العثمانية، إلى محاربته في مطلع القرن التاسع عشر. ومن جهة أخرى، أولى كثير من الكتّاب اهتمامهم بـ الدروز، الذين استقرّوا منذ زمن بعيد في جبال المشرق الساحلية، وتعود أصولهم إلى القرن العاشر الميلادي. وقد كتب جان-ميشيل دو فنتر دو براديس (1739–1799) مذكرة في تاريخ الدروز، شعب لبنان. أما الدبلوماسي أوجين بوجاد (1815–1845)، فقد تناول في الجزء الأول من مؤلفه سوريا ولبنان الكتابات السرّية الخاصة بالدروز أنفسهم.
أما فيما يتعلّق بإنتاج المؤلفين المحليين ، فقد كان لا بدّ من انتظار نهاية القرن التاسع عشر كي تظهر كتاباتهم بصورة تنأى عن الماضي وتتميّز عنه. فمع تزايد النفوذ الأوروبي، بل وهيمنة الدول الأوروبية على أراضي المشرق، برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ردّة فعل فكرية ودينية في آنٍ واحد. هذه الحركة الفكرية ستُمهّد لظهور تيار الوحدة الإسلامية، الذي تبلور حول شخصيات رحالة كان من أبرزها الإيراني جمال الدين الأفغاني (1838–1897). وقد أقام هذا الأخير في مصر ما بين 1871 و1879، حيث أثّر في عدد من علماء الأزهر، ومنهم محمد عبده (1849–1905)، الذي سيُعدّ لاحقًا أحد أبرز رموز الإصلاح الديني في العالم الإسلامي. ولا شكّ في أنّ التيارات الدينية المتشددة الراهنة، التي غذّتها الحروب الحديثة التي عصفت ببلدان المشرق الإسلامي بعد استقلالها منتصف القرن العشرين، إنما تستمدّ جذورها الفكرية لا من تاريخ الإسلام الأول في القرن السابع الميلادي، بل من التيارات الأيديولوجية الدينية التي صاغت في أواخر القرن التاسع عشر مفهوم السلفية، باعتباره عودةً إلى ماضٍ مؤسّس مثالي.