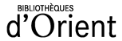وفي نهاية القرن الثامن عشر، بدت الإسكندرية وكأنها مدينة في حالة انحدار بالنظر إلى مجدها القديم، ولم يصفها أعضاء الحملة المصرية إلا بالآثار والخراب.
تقديرات عدد سكانها صعبة – يمكننا تقدير عددهم بحوالي 15,000 نسمة تقريبًا – على العكس من ذلك، يظل دورها التجاري والعسكري مهمًا: فهي منفذ لمصر وللأراضي الداخلية البعيدة التابعة لها (شبه الجزيرة العربية، الهند، والشرق الأقصى)، وتعد أحد المصادر الأساسية لتوفير المواد الغذائية (القمح، الأرز)، والمعدات العسكرية (الحبال، القطن، الحبك)، والمنتجات الغريبة للإمبراطورية العثمانية.
الوثائق التي أعدها أعضاء الحملة على مصر، تقدم لنا رؤية عن مدينة منقسمة إلى وحدتين: من جانب توجد المدينة العثمانية التي تأسست ابتداءا من عام ١٥١٧ على اللسان الواقع بين جزيرة فاروس وأرض البر الرئيسي، ومن جانب آخر المدينة القديمة التي يحيط بها سور طولوني، مع بعض مناطق السكنية ولكن يوجد أيضاً بساتين ومساحات من الآثار. هناك ثلاثة أثار قديمة تجذب انتباه العلماء كما شدت انتباه الرحالة فى القرون السابقة، سراديب المدافن، العامود المسمى بومبى الذى نصب على شرف ديوكليس عام ٢٩٧م داخل حرم معبد سرابيس ، "مسلات كيلوبترا" من عصر تحتمس الثالث والتى أحضرها أوغسطوس من هليوبوليس فى العام ١٣ قبل ميلاد والتى تزين مدخل المعبد المخصص للعبادة الإمبراطورية.
أدى الاحتلال الفرنسي القصير قبل كل شيء إلى تعزيز تحصينات المدينة وتحسين المنازل فيالحى الإفرنجى. بعد سنوات الإضراب التي قادت محمد على إلى الاستيلاء الفعلي على السلطة, شهدت المدينة عودة إلى الأنشطة التجارية وخدمات البلدية. وإن حفر قناة المحمودية بإشراف المعمارى كوست (١٨١٨- ١٨٢١) ضمن التزويد المنتظم بالمياه، كما ربطت الميناء بباقي مصر وأدت إلى توسع الأراضي الزراعية والسكنية الريفية. تم تعديل التحصينات بإشراف كوست ثم فى مرحلة ثانية (١٨٤٠-١٨٦٠) تحت إشراف الكولونيل المهندس جاليس.
كان لتوسيع وتطوير الميناء والترسانة (1835-1840)، بقيادة ل. ش. ليفبور دو سيريزي ود. إي. موغيل، دورٌ كبيرٌ أيضًا. في هذه المدينة الساحلية العسكرية، طوّر التجار الفرنسيون والقناصل الأوروبيون منطقةً جديدةً أكثر اتساعًا بالقرب من الميناء الشرقي، الذي كان منفذهم الوحيد حتى عام 1830. تركزت هذه المنطقة حول حي جديد اكثر انفتاحاً، الذي أصبح ساحة القناصل عام 1855، وفي عام 1867، ساحة محمد علي (حيث أقيم، ابتداءً من عام 1872، تمثال محمد علي على صهوة حصان، للنحات هـ. جاكيمارت). كان هؤلاء التجار، المستأجرون وتجار السلع التصديرية، يقيمون مراكزهم التجارية في ميناء البصل (ميناء البصل) عند مصب قناة المحمودية.
انتاج القطن وتجارته التي ازدهرت بفضل دخول نوع من القطن طويل البتلة إلى مصر بواسطة جوميل بداية من 1823، شهد قفزة في سنوات 1860 بسبب توقف إمدادات الولايات المتحدة التي تعيش حرباً أهلية. في نفس اللحظة في ظل حكم عباس ثم إسماعيل أدى تحسين وسائل المواصلات (سفن بخارية ذات حمولة عالية، سكك حديدية بين القاهرة والإسكندرية وباقي مصر) ووسائل اتصالات سلكية ولاسلكية وميناء الإسكندرية نفسه إلى وضع المدينة في حقل الاقتصاد العالمي. م يُعرّض افتتاح قناة السويس تجارة الإسكندرية للخطر، بل عززها بترسيخ هيمنتها على حركة المرور المصرية. شهدت هذه الفترة تدفقًا للأجانب (رعايا أوروبيين أو تحت حماية الدولة العثمانية)، حيث ارتفعت نسبتهم من 11% من السكان (104,189 نسمة) عام 1848 إلى حوالي 20% من السكان (232,000 نسمة) عام 1882.
إن المواجهة بين القوى الأوروبية والحركة الوطنية المصرية، التي أدّت إلى قصف الإسكندرية من قبل الأسطول البريطاني في يوليو عام 1882، أسفرت عن إقامة نظام اقتصادي استعماري وهيمنة بريطانية على البلاد. وقد أُعيد بناء الحيّ الأوروبي، مع تنفيذ الترتيبات الجديدة في ميدان محمد علي والحدائق الفرنسية، وامتد شرقًا نحو محطة القاهرة وبوابة رشيد.
شهدت السنوات ما بين 1882 و1890 ميلاد بلدية الإسكندرية، التي ضمّت أعضاء مصريين وأجانب من كبار ملاّك الأراضي ورجال الأعمال، وجعلت من مهمتها إدارة الفضاء الحضري، بدءًا من الطرق والمياه والإنارة وصولًا إلى الخدمات الصحية. وكانت اللغة التي يستخدمونها في معاملاتهم هي الفرنسية، التي حلّت محل الإيطالية منذ ستينيات القرن التاسع عشر.
حتى الحرب العالمية الأولى، سيطر هؤلاء الأعيان ذوو الأصول المتوسطية - الشامية واليونانية واليهودية - المستقرون في مصر، بلا منازع على المدينة التي بلغ عدد سكانها عام ١٩٠٧ حوالي ٤٠٠ ألف نسمة. أدخلوا جميع مقومات المدينة الأوروبية: بورصة، وتأمين لحماية مستودعاتهم ومساكنهم الرئيسية، وقطار خفيف، وممشى ساحلي أُنشئ بفضل استصلاح الأراضي، ومؤسسات ثقافية ورياضية، بما في ذلك المتحف اليوناني الروماني، وكازينو سان ستيفانو الواقع في منطقة الرملة السياحية، أو لاحقًا، استاد الإسكندرية الكبير، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية التابعة لكل جالية.
أثناء الحرب العالمية الأولى كانت الإسكندرية القاعدة الخلفية لجبهة الشرق، وفى عام ١٩١٧ أثناء حملة الدردنيل تحولت إلى مدينة للمستشفيات ولمعسكرات الحلفاء وللمرضى والمساجين.
إن الحركات الوطنية في عام 1919، وقانون الجنسية المصرية الصادر عام 1926، واتفاقية مونترو عام 1937 التي أنهت نظام الامتيازات الأجنبية، أسهمت جميعها في تقويض النظام البريطاني، واستقلال البرجوازية المشرقية، والنموذج الاقتصادي الليبرالي.
لكن لم يكتمل الانفصال إلا في وقت لاحق، بين عامي 1952 و1961، حين تم الانقسام النهائي بين أولئك الذين كانوا في السابق جماعات طائفية فأصبحوا أقليات، وأولئك الذين كانوا يُعدّون من السكان الأصليين فأصبحوا مواطنين مصريين كاملين.
الصورة: الاسكندرية الجمرك، كارت بوستال