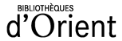إن واحدة من السمات التي تفرد بها أناتول فرانس في زمنه، مقارنة بكل من "لوتي" و"موباسان" و"لوميتر"، ومقارنة أيضا بالأجيال الرومانسية والبرناسية، تتمثل بدون شك في أنه يكاد لا يكون بالمرة كاتبا استشراقيا. ومن الوارد أن هذه الوضعية غير المريحة قد كانت عاملا في نجاحه، قبل أن تصير لاحقا سببا لفقدانه مكانته.
إن واحدة من السمات التي تفرد بها أناتول فرانس في زمنه، مقارنة بكل من "لوتي" و"موباسان" و"لوميتر"، ومقارنة أيضا بالأجيال الرومانسية والبرناسية، تتمثل بدون شك في أنه يكاد لا يكون بالمرة كاتبا استشراقيا. ومن الوارد أن هذه الوضعية غير المريحة قد كانت عاملا في نجاحه، قبل أن تصير لاحقا سببا لفقدانه مكانته.
لم يكن أناتول فرانس، الذي اعتبر تجسيدا للذوق الفرنسي في الآداب، كاتبا رحالة، أو مُمَرِّرا للآداب الأجنبية. فهذا الكلاسيكي الجديد، الشغوف بالعصر القديم وبالنهضة الإيطالية، والمعجب بالرسام "برودون" أكثر من إعجابه بالرسام "دو لاكروا"، لم يستشعر غواية المشرق إلا بمقدار ضئيل. وبالإضافة إلى ما تميزت به نزعته الإنسانية من صرامة وتبات، فإنه يمكن من دون شك اعتبار نزعته المعادية للاستعمار، التي كانت بدورها أمرا نادرا في ذلك الوقت، بمثابة الوجه الإيجابي والمشرق لهذا التجاهل الصريح.
وبالرغم من هذا الصمت، فإن أعماله الغزيرة تزخر بنصوص استشراقية عظيمة.
من المؤكد أن "ثاييس" (1890)، تلك الرواية التي أوحت للموسيقي جول ماسينيه بالأوبيرا الشهيرة التي ألفها سنة 1894، والتي تتخذ هيئة "قصة فلسفية" طويلة صيغت في صورة سيرة دينية بأسلوب ساخر يحمل تأثيرات فلوبيرية، قد ظلت منشدة إلى العالم الهيليني، وإن في صورته الهيلينستية. لكن الإسكندرية ترمز فيها بالتحديد إلى التلاقي الشائك بين العالمين الوثني والمسيحي، وهي بذلك تطرح مسألة إضفاء اليهودية-المسيحية للطابع الشرقي على الثقافة الكلاسيكية. وبالطبع، فإن غرائبية الشرق القديم تحضر فيها بقوة. فالإسكندرية كما تصفها الرواية، أي باعتبارها مدينة التباينات القاسية، مع «بؤسائها القابعين في ظل» باب الشمس، ومشاهدها الخليعة، تتطابق مع موضع معروف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أناتول فرانس يجعل من نفسه بهذه المناسبة رسام مشاهد، فيصف الصحراء والنيل وأبا الهول. وهو يتسلى أيضا، مثل تلميذ بعيد لفرانسوا الأسيزي، بالغرائبية الحيوانية: فالمشاهد المرسومة لطيور أبي منجل على نهر النيل («أب مصر») تقابلها الأطياف الساخرة لبنات آوى الماكرة حول الناسك بافنوس، باعتبارها مؤشرات تكشف بطريقة فرويدية اللاوعي الإيروتيكي الذي يعتمل داخل رغبته في هداية الغانية الشيطانية ثاييس. الشخصيات مُشْرَبة هي أيضا بالبعد الغرائبي. فثاييس قد تلقت، وهي طفلة، البشارة والتعميد من قِبَل عبد أسود، هو أحميس المعروف باسم ثيودور، قُدِّم في الرواية بأوصاف ثقافية تنتمي إلى ذلك العصر: "قعد على كعبيه، الساقان مطويتان، ونصفه الأعلى منتصب، في الوضعية الموروثة أباً عن جدٍّ من قِبَل بني عرقه كافة». يستثمر أناتول فرانس أيضا التنافر بين هذه الشخصية وبين الحفلة الشعائرية للطقس الديني الأول الذي أقيم للفتاة الصغيرة في نهاية رقصة محمومة "حدقوا فيها بعيون واسعة وأظهروا أسنانهم اللامعة وهم يبتسمون". ويخلص من ذلك إلى القول بأسلوب ماكر: "على هذا النحو تلقت ثاييس التعميد القدسي ". وإذا كان ذكر العرب يرد أحيانا في هذه الرواية، فإنما هو من قبيل الكلام العابر، ومن طبيعة الحال فإن الإسلام غائب عن هذا الشرق، شرق القرن الرابع، مثلما هو غائب كذلك عن عمليه الآخرين اللذين يندرجان ضمن إطار المشرق.
تاريخ المسيحية هو وحده ما كان قد نجح أيضا في توجيه أناتول فرانس إلى الشرق في روايته السابقة التي حملت عنوان "بلتازار" (1889). هذه القصة، التي تبدأ مثلما تفعل "ثاييس" بنفس عبارة التذكير الأثيرة عند الراوي («في ذلك الزمان»)، والتي منحت اسمها لمجموعة مختلطة من القصص التي لا يمثل فيها الشرق مصدر إلهام أساسي، تدس في الكتابات المقدسة المغامرات العاطفية لبالتازار وبلقيس، ملكة سبأ، فيما يشبه توطئة خيالية لرحلة الملك الساحر إلى الأرض المقدسة. ومثلما في إحدى قصص ألف ليلة وليلة، يهيم العاشقان متنكرين، لأن بلقيس تريد أن تختبر الشعور بالخوف. أما بالتازار، الذي ندم وتاب ثم هدأ وتعقل بفعل دراسة الفلك، فقد اصطفته السماء لتتبع النجم المبشر بميلاد المخلص. إن هذا التصوير الذي يحمل بصمات نهاية القرن لأسطورة المرأة الحسناء/اللعوب، الشرقية بالضرورة، يرتبط إذن بإعادةِ كتابةٍ، تهكمية وساخرة بالضرورة، للإنجيل.
إن أناتول دو فرانس، المقتنع بما ورثه من تصورات عن أستاذه رينان وعن التاريخ المقارن لزمنه، يولي إذن اهتمامه بالأساس للحظة التي شرع فيها الغرب، بفعل المسيحية الفتية، في الانقلاب نحو الشرق. ورغم أن المشهد يجري في اليونان التي يحيل عليها عنوانها، فإن القصيدة الدرامية "الأعراس الكورنثية" (1876)، تحكي نفس قصة «رب الجليليين» الذي جاء ليخيم بظلاله على بلاد اليونان الكلاسيكية. لم ينفلت أناتول فرانس، العلماني والملحد والرافض للدين والمسيحية، بل الوثني الجديد نزوعا بفعل الليبرالية السياسية، من شكل من الريبة المعادية للشرق التي يمكن أن تفسر كذلك الاحتفاء الذي قوبل به، قبل انخراطه في قضية دريفوس وأيضا بالرغم من هذا الانخراط لاحقا، من قِبَلِ حركة العمل الفرنسي ذات التوجه القومي العقلاني.
ومجددا، فإن "حاكم يهوذا" (1892، الواردة في مجموعة "صدفة اللؤلؤ")، القصة الأكثر شهرة للمؤلف والتي أجمع النقاد من بارِّيس إلى شاشا على الإشادة بها، هي شذرة من إنجيل منحول، مكتوب هذه المرة من وجهة نظر بيلاطس البنطي نفسه. لقد انبهر أناتول فرانس بالهوة السحيقة التي تفصل تصور العالم عند رومان الإمبراطورية عن نظيره عند الطائفة المسيحية. وهو يشدد هنا، كما سيفعل لاحقا في السلسلة التي نشرها تحت عنوان "فوق الصخرة البيضاء" (1905)، على الأصول الشرقية للمسيحية التي تمثل مريم المجدلية ماهيتها النسوية وتجسيدها الحسي. وبخصوص هذه النقطة كما هو الشأن بخصوص نقط أخرى، فإنه يمكن النظر إلى رؤيته بموازاةٍ مع أطروحات معاصره فريدريك نيتشه. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه النزعة التاريخانية المعادية لليهودية لم تصل أبدا عند فرانس إلى نظيرتها المعتادة، أي نزعة معاداة السامية التي رفضها دائما بحزم كبير، طالما أن الأمر لم يكن يتعلق عنده إلا بإعادةِ قراءةٍ لتاريخ المسيحية بمقاصد تحررية، في إطار تقليد التنوير الفولتيري. وسيرا على نفس المنوال، فقد حرص فرانس أشد الحرص، عندما دافع عن الأرمن الذين تعرضوا للاضطهاد سنة 1897 ثم سنة 1915، على أن لا يجعل من هذه المعركة الإنسانية قضية دينية أو حضارية تتصل بالديانة الإسلامية التي كانت بالفعل تعتبر آنذاك ديانة بعيدة، وتقع بالتالي خارج نطاق النقد العلماني الصريح والمباشر، الذي تمثلت ثمرة نضاله المستميت في قانون الفصل بين الكنيسة والدولة (1905).
.الصورة : Anatole France. Estampe par A. Zorn. 1906